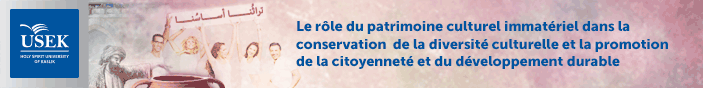ليس لبنان بمنأى عن غليان الأحداث في سوريا، إذ تجمع البلدين علاقة شديدة التداخل والتعقيد. وفي طرابلس مثلًا، بدا مشهد تظاهر عشرات الشبان تأييدًا للرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، على خلفية الأحداث الدامية في السويداء، مشهدًا نمطيًا يُراد منه الإيحاء بأن المدينة ذات الغالبية السنية تؤيد خيارات الشرع الطائفية والسياسية، لا سيما مع رفع أعلام جبهة النصرة.
لكن هذا المشهد، لم يكن بريئًا ولا عفويًا. بل بدا مدبّرًا بعناية أمنية وسياسية، بهدف خلق انطباع شعبي داعم للشرع في مدينة شديدة الحساسية مثل طرابلس.
هذا التصوير المتعمد لطرابلس، على أنها حاضنة لخيارات “سوريا الشرع” ورجال أمنه، لا يعكس حقيقة المدينة المتنوعة، التي تضم طيفًا واسعًا من الآراء والتيارات، والتي تدعو إلى سوريا حرة لكل أبنائها وأطيافها، وترفض أي شكل من أشكال الانتهاكات وإراقة الدماء على أساس الطائفي. غير أن السلطات اللبنانية، تاريخيًا وراهنًا، تتحمل مسؤولية كبيرة في تغذية هذا الاضطراب، تحديدًا عبر إهمال ملف “الموقوفين الإسلاميين”، الذي يضم داخله معظم الموقوفين السوريين أيضًا.
ملف بخلفيات معقدة
وإذا تأملنا هوية المتظاهرين المؤيدين للشرع في طرابلس، سنجد كثيرًا منهم ممّن دفعوا ثمنًا باهظًا خلال الحرب السورية. إذ اعتُقلوا ووصِموا بالإرهاب نتيجة تأييدهم للثورة أو انخراطهم في صفوفها، بمن فيهم عناصر من جبهة النصرة.
اليوم، لا يزال المئات من هؤلاء، لبنانيين وسوريين وبعض الفلسطينيين، قابعين في السجون، وشريحة واسعة منهم بلا محاكمات، في وقت تطالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن سجنائها في لبنان. وهنا تبرز الحاجة إلى فهم السياق الكامل لهذا الملف، الذي لا يبدأ بالحرب السورية فحسب، بل يعود إلى أحداث الضنية عام 1999، ويتسع على امتداد ربع قرن من التراكمات السياسية والأمنية.
أصل التسمية
“الموقوفون الإسلاميون” هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى مجموعة من السجناء اللبنانيين، ينتمي معظمهم إلى الطائفة السنية، إلى جانب عدد من السوريين والفلسطينيين. ومن ضمن هذه المجموعة، تبرز قضية “الموقوفين السوريين”.
بدأ تداول هذا الوصف – الموقوفين الإسلاميين – مطلع الألفية، عقب أحداث الضنية في شمال لبنان عام 2000.
وشمل لاحقًا كل من وُجّهت إليهم اتهامات بالضلوع في تفجيرات واشتباكات مسلّحة مع الجيش اللبناني، أو بالقتال في سوريا إلى جانب فصائل مختلفة وعلى رأسها جبهة النصرة.
وقد صدرت بحق بعضهم، أحكام قاسية من المحكمة العسكرية وصلت إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
الشرارة الأولى: 1999
بدأت الشرارة الأولى في الأول من تشرين الأول عام 1999، حين ألقى مجهولون عبوة ديناميت على كنيسة مار جاورجيوس في منطقة الزاهرية بطرابلس.
يومها، أوقف الجيش عددًا من الشبان المنتمين إلى تيارات إسلامية، ثم أفرج عنهم لاحقًا لعدم كفاية الأدلة. غير أن بعضهم توارى عن الأنظار ولجأ إلى منطقة جرد النجاص في أعالي الضنية.
مع نهاية العام، وتحديدًا في ليلة رأس السنة 1999 وصباح 4 كانون الثاني عام 2000، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني ومجموعة مسلحة إسلامية في جرود الضنية، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الجيش، فيما سقط عدد من المسلحين بين قتيل وموقوف.
وفي عام 2005، وبعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، صدر قانون عفو عام شمل العديد من المحكومين، من بينهم عناصر من الضنية، كما شمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ما أدى إلى الإفراج عن معظم الموقوفين في هذا الملف، وبقي آخرون في السجن لاتهامهم بقتل عناصر من الجيش.
نهر البارد والتحول الكبير:2007
شكلت اشتباكات مخيم “نهر البارد” للاجئين الفلسطينيين، أخطر تحول شهدته قضية الموقوفين الإسلاميين.
في عام 2007، شهد شمال لبنان واحدة من أعنف المواجهات العسكرية بين الجيش اللبناني وتنظيم “فتح الإسلام”، الذي كان قد اتخذ من المخيم معقلًا له.
بدأت المعركة بهجوم مباغت شنه مقاتلو التنظيم على مراكز الجيش في محيط المخيم، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود والمدنيين، وسرعان ما تحوّل إلى ساحة حرب مفتوحة استمرت لأشهر.
من 20 أيار وحتى 3 أيلول من العام نفسه، تصاعدت المواجهات إلى معركة دامية خلّفت أكثر من 160 قتيلًا في صفوف الجيش اللبناني، ونحو 220 من عناصر التنظيم، إلى جانب دمار شبه كامل للمخيم ونزوح عشرات الآلاف من سكانه.
أسفرت معركة “نهر البارد” عن توقيف المئات من “الإسلاميين”، معظمهم من اللبنانيين مع عدد من السوريين والفلسطينيين.
تُقدر أعداد الموقوفين على خلفية أحداث نهر البارد بأكثر من 500 موقوف، أدرجوا لاحقًا تحت تصنيف “الموقوفين الإسلاميين”. وبعد سنوات طويلة من الاحتجاز، لم تتجاوز حالات التبرئة 45 شخصًا، أُطلق سراحهم بعد قرابة 14 عامًا من السجن. أما الباقون، فقد صدرت ما بين 150 و170 منهم أحكاماً بالسجن لمدة عامين، فيما نال آخرون أحكامًا تصل إلى 15 عامًا، بينما واجهت قلة منهم أحكامًا مشددة تراوحت بين السجن المؤبد والإعدام.
جولات قتال متتالية
شكلت جولات القتال الطائفي بين جبل محسن وباب التبانة، بعد الحرب في سوريا، ذروة جديدة في قضية الموقوفين الإسلاميين.
وقد تسببت الحرب السورية في تأجيج الصراع في طرابلس بين منطقتي باب التبانة، ذات الغالبية السنية المعارضة للنظام السوري السابق، ومنطقة جبل محسن، ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السابق.
حتى عام 2014، شهدت المنطقتان 21 جولة قتال، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى المدنيين من المنطقتين. انتهى الصراع بتدخل سياسي وحكومي، حيث تم تنفيذ خطة أمنية أسفرت عن اعتقال العشرات من الشباب، الذين أضيفوا إلى قائمة الموقوفين الإسلاميين أيضًا، لا سيما من باب التبانة.
معركة الأسير: 2013
في حزيران 2013، اندلعت معركة عنيفة في منطقة عبرا قرب صيدا، قادها الشيخ أحمد الأسير ومجموعة من أنصاره انطلاقًا من مسجد بلال بن رباح. وخاض مع مجموعته اشتباكًا مسلّحًا ضد عناصر من حزب الله والجيش اللبناني. أسفرت المواجهات عن سقوط عدد كبير من الضحايا مدنيين وعسكريين، وتبعها تنفيذ الجيش حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشبان.
وفي آب 2015، أُلقي القبض على أحمد الأسير، وصدر بحقه حكم بالإعدام. وفي عام 2021، أدين مجددًا بتهم تتعلق بأحداث بلدة بحنين عام 2014، وصدر حكم إضافي بسجنه 20 عامًا مع تجريده من حقوقه المدنية.
وثائق الاتصال
في تلك المرحلة، تخطّى عدد الموقوفين الإسلاميين الخمسة آلاف، وتركّز وجودهم بشكل خاص في سجن رومية، داخل المبنى المعروف بـ “المبنى باء”.
كما أن جزءًا كبيرًا من الموقوفين الإسلاميين دخلوا السجن استنادًا إلى “وثائق الاتصال” التي كانت تصدر عن وزارة الدفاع اللبنانية، وبقيت إلى اليوم مصدر شكوك بشأن قانونيتها. وقد تجاوز عدد هذه الوثائق 11 ألفًا، وصدرت بحق شبّان اتُّهموا بالتخابر أو القتال إلى جانب فصائل إسلامية مسلحة في سوريا خلال الحرب.
وبموجب وثائق الاتصال، جرى تعميم أسماء الملاحقين بها على الحواجز والأجهزة الأمنية، وقد أُودع عدد كبير من الشبان، لبنانيين وسوريين في السجون، استنادًا فقط إلى هذه الآلية.
ارتباط المصير
ويُقدّر عدد الموقوفين الإسلاميين بحوالي 400 معتقل، من بينهم نحو 170 سوريًا، والبقية لبنانيون إضافة إلى عدد من الفلسطينيين، وذلك بعد الإفراج عن المئات منهم بعد انتهاء محكوميتهم.
بيد أن أحدث الأرقام، تتحدث عن موجود نحو ألفي موقوف سوري في السجون اللبنانية والعشرات منهم من دون محاكمات. وقرابة نحو 800 منهم، متهمون بقضايا يضعها القضاء العسكري ضمن الجرائم الإرهابية.
عمليًا، يرتبط ملف الموقوفين السوريين في لبنان، بملف الموقف من الإسلاميين ارتباطًا جذريًا. ما يعني أن إيجاد تسوية للأول، يتطلب حل الثاني.
المعضلة الثانية التي تواجه الموقوفين السوريين والاستجابة إلى مطالب تسليمهم للسلطات السورية، هي أن الاتفاقية القضائية الموقعة بين بيروت ودمشق عام 1951 لا تشمل تسليم المحكومين الذين ارتكبوا جرمًا على أراضي الدولة المسجونين بها، لا سيما في قضايا الإرهاب والاعتداء على الجيش.
هكذا إذن، لا يبدو أن ملف الموقوفين الإسلاميين والسوريين في لبنان يسير نحو تسوية قريبة، في ظل تعقيدات قانونية، وغياب الإرادة السياسية، واستمرار التوظيف الأمني السياسي لهذا الملف مع تدهور الأوضاع من جديد في سوريا. وبينما تطالب دمشق باستعادة مواطنيها السجناء، يتمسك القضاء اللبناني باشتراطات قانونية تمنع التسليم، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالإرهاب.